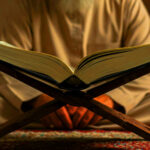QURBAN DULU ATAU AQIQOH YANG UTAMA
Asslamualaikum
Deskripsi masalah.
Sebagaimana yang kita maklumi bahwa hukum asal qurban dan aqiqoh adalah sama-sama sunnah artinya hukum dari kedua sama bersis namun bedanya hanyalah waktu dan pelaksanaannnya kalau qurban waktu dan pelaksanaanya pada bulan Dzul hijjah mulai tgl 10-13 sedangkan pelaksanaannya aqiqoh kapanpun saja, tidak terikat waktu yang penting ada kemampuan untuk mengaqiqohkan anaknya atau untuk dirinya sendiri, Namun ada musykil dari keduanya yaitu:
Pertanyaannya.
Lebih utama mana melaksanakan qurban dulu atau aqiqah dulu..?
Jawaban.
Keutamaan salah satu dari keduanya adalah Dikondisikan artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya orang yang punya niatan .
Maksud dikondisikan artinya harus ditinjau dari hukumnya terlebih dahulu walaupun keduanya hukum asal adalah sunnah muakkad .Namun salah satu dari keduanya terkadang berubah menjadi wajib, itu bisa terjadi karena ada sebab, bisa karena ditakyin atau karena Nadzar.
Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah
الحكم يدور مع علته وجودا وعداما
Hukum itu bisa berubah ada dan tidak ada beserta ellatnya
Misalkan dihadapkan pada dua kewajiban : Niatan aqiqoh nazar sedangkan qurbannya wajib , maka yang harus didahulukan adalah yang wajib dari pada nazar , apalagi dihadapkan pada dua maslahah semisal niatan kurban sunnah, sedangkan aqiqoh niatannya wajib, maka lebih utama wajib dari pada sunnah.
Dan sebaliknya jika kurbannya niat qurban wajib sedangkan niatannya aqiqoh hanya niatan sunnah tentu lebih utama yang wajib karena perkara wajib jika dilaksanakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa, sebagaimana kèterangan dalam kitab mabaadi’ul fiqh yaitu:
الواجب هو مايثاب على فاعله ويعاقب على تاركه
Berbeda dengan hukum sunnah jika dikerjakan berpahala dan jika ditingkatkan tidak berdosa.
المندوب هو مايثاب على فاعله ولايعاقب على تاركه
Begitu juga halnya dengan qurban wajb dan aqiqoh nadzar atau sebaliknya maka tetap diantara keduanya ada yang harus didahulukan yaitu yang wajib/fardhu.
Oleh karenanya Jika seseorang dihadapkan pada dua kemaslahatan maka lakukanlah ( dahulukannlah ) yang lebih tinggi nilai keutamaannya. Dan jika dihadapkan pada dua kerusakan maka lakukanlah yang ringan atau ambillah yang lebih ringan kerusakannya.
شرح رسالة مختصرة في أصول الفقه
قاعدة المصالح والمفاسد
وَإِذَا تَزَاحَمَتْ مَصْلَحَتَانِ؛ قُدِّمَ أَعْلاَهُمَا، أَوْ مَفْسَدَتَانِ لاَ بُدَّ مِنْ فِعْلِ إِحْدَاهُمَا؛ ارْتُكِبَتْ أَخَفُّهُمَا مَفْسَدَةً.
قال: (وإذا تزاحمت مصلحتان؛ قُدِّمَ أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما؛ ارْتُكِبَ أخفُّهما).
هذه القاعدة تسمى عند العلماء: قاعدة المصالح والمفاسد، وقاعدة المصالح والمفاسد لها ثلاث صور، ذكر الشيخ صورتين، وترك الصورة الثالثة.
الصورة الأولى: أن تتزاحم مصلحتان، والتزاحم معناه التعارض بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما، فعندنا مصلحتان ولا يمكن الجمع بينهما، ولا بد أن نفعل مصلحة واحدة؛ فما الحكم؟!
قال الشيخ: إنه يختار أعلى المصلحتين؛ مثل شخص اجتمع عليه دين ونفقة مستحبة؛ كصدقة، فقضاء الدين مصلحة، والنفقة المستحبة على الفقراء والمساكين مصلحة، فأيهما يُقَدِّمُ؟ يقدم قضاء الدين؛ لأن قضاء الدين واجب، هذا الآن تعارض بين مصلحتين إحداهما واجبة والأخرى مستحبة.
طيب.. لو تعارضت مصلحتان واجبتان؛ مثل صلاة نذر وصلاة فرض، يُقدم صلاة الفرض على صلاة النذر؛ لأن الفرض ثبت بأصل الشرع، والنذر أوجبه المكلف على نفسه، وفي النفقة اللازمة للزوجات والأقارب تُقَدَّمُ نفقة الزوجات ثم الأقارب، إذا تعارض عند الزوجة أمر أبويها وأمر زوجها؛ يُقَدَّمُ أمر زوجها؛ لأنه آكد.
إذا اجتمعت مصلحتان مسنونتان؛ قُدِّمَ أفضلهما، ويقدم ما فيه نفع متعدٍّ، فلو تعارض عند إنسان طلب علم وصلاة نفل؛ يقدم طلب العلم. تعليم العلم مع صلاة نفل، تعليم العلم، المقصود من هذا: أن الأعلى في المصالح يختلف من مصلحة إلى أخرى.
ومن الأدلة على اختيار أعلى المصلحتين: ما ورد في الحديث الصحيح قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن الزبير(١) عن عائشة قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ» قال ابن الزبير: بِكُفْرٍ، « لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ»(٢).
فهنا عندنا مصلحتان: المصلحة الأول: نقض الكعبة وجعل لها بابين، وإذا كان لها بابان يكون أخفَّ وأسهل من كون الناس يدخلون ويخرجون مع باب واحد، والمصلحة الثانية: تأليف قلوب قريش؛ لأنهم لا يزالون حدثاء عهد بكفر، فماذا قدم الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المصلحتين؟ قدم المصلحة الثانية، وهي تأليف القلوب.
الصورة الثانية: إذا اجتمعت مفسدتان؛ ارتكب أخفهما، ومن أدلة هذا وأمثلته: ما ورد في الحديث الصحيح حديث أنس -رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي فبال في المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليه(٣).
البول في المسجد مفسدة، والاستمرار على البول مفسدة، والصحابة -رضي الله عنهم- أرادوا أن يقطعوا على الرجل بوله، يعني أرادوا أن لا يستمر البول. والرسول -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يستمر البول.
إذن: البول في المسجد مفسدة في حد ذاتها، واستمرار البول مفسدة، فأراد الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يقضوا على الاستمرار، فنَهوا هذا الرجل لأجل أن يقوم ويُكمل بوله خارجَ المسجد، لكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهاهم. لماذا؟ لأن قطع البول مفسدته أعظم من مفسدة الاستمرار، والبول في المسجد، وكونه يستمر على بوله هذا أهون، وكونه يقوم ويخرج هذا أعظم، فارْتُكِبَتْ أدنى المفسدتين وأخف المفسدتين؛ لأنه إذا قام سيكون هناك ثلاث مفاسد:
المفسدة الأولى: حبس البول، والإنسان إذا أراد أن يبول وحَبَسَ البول هذا مُضِرّ.
المفسدة الثانية: أنه سينجس أكبر بقعة من المسجد، وبوله كانت بقعة معينة ما يعني تزيد على بضعة من السنتيمترات، لكن إذا قاموا وطردوه سيكون هناك شيء من البول يخرج هذه مفسدة ثانية.
المفسدة الثالثة: أن ثيابه ستتنجس، لكن إذا بقي البول بالمسجد حصل ستتلاشى المفاسد هذه.
إذن: الرسول -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا نهاهم أراد ارتكاب أدنى المفسدتين في مقابل أعلاهما.
الصورة الثالثة: إذا تقابلت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أعظم.. انظر الآن الصورة الأولى عندنا مصلحتان، والصورة الثانية عندنا مفسدتان، والصورة الثالثة عندنا مصلحة ومفسدة، ولكن المفسدة أعظم، فما الحكم؟ يُقدم دفع المفسدة ويُترك تحقيق المصلحة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلْب المصالح.
ومن أدلة هذا قول الله -تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾(٤)، سبوا آلهة المشركين هذه مصلحة، وهي تحقير دينهم وعبادتهم، وسب الله -تعالى- هذه مفسدة، ولما كان سيترتب على هذه المصلحة التي هي سب آلهة المشركين سيترتب عليها مفسدة وهي سب الله -تعالى- تُركت هذه المصلحة، قال -تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾.
ومن الأمثلة على هذا ما ورد من زَوَّارَات القبور(5)، فزيارة القبور للنساء فيها مصلحة، وهي الاتعاظ ولكن فيها مصلحة أعظم وهي مفسدة فتنة الأحياء من جهة، وإيذاء الأموات من جهة أخرى، فقُدِّمَ درء المفسدة على جلب المصلحة.
ومن الأمثلة أيضًا منْع الجار من أن يَتَصَرَّفَ في ملكه إذا أَدَّى إلى الإضرار بجاره، فكون الجار يتصرف في بيته هذه مصلحة، ولكن كونه يضر الجار هذه مفسدة.
يعني لو أن إنسانا يبيع الغنم، وقال: الحوش بعيد عني، وسأجعل الغنم عندي بالبيت، فوضعهم في بيته، وبجانبه جدار جاره، كونه الآن قَرَّبَ الغنم له في بيته مصلحة له، ولكن جاره تأذى من رائحة الغنم هذه مفسدة أيهما الذي يُقَدِّمُ؟ يُقدم درء المفسدة، نكتفي بهذا القدر والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
يسأل أحد الإخوة؛ يقول: كيف نجمع بين قاعدة “الوسائل لها أحكام المقاصد” وبين قاعدة “الغاية لا تبرر الوسيلة”؟
أولا: العلماء يفرقون بين الوسيلة وبين الذريعة، وقد ذكرني السؤالُ، فقالوا: الوسيلة هي ما توصل إلى المقصود قطعا أو ظنا، والذريعة قد لا تُوصل إلى المقصود.
المثال الذي يوضح: مصاحبة شخص منحرف أو مصادقة ومحبة شخص منحرف، أيهما أبلغ في التأثر؟ المصادقة والمحبة أبلغ في التأثر؛ إذن: نقول: المصادقة هذه وسيلة، ومجرد مصاحبة بطريق مثلا هذه تعتبر ذريعة.
فالقول هنا بأن الغاية تبرر الوسيلة هذا عكس للقاعدة التي ذكرها العلماء؛ لأن العلماء ما يقولون: المقاصد لها أحكام الوسائل. إذن لا يُنظر إلى الغاية بحيث تبرر الوسيلة أو ما تبررها؛ وإنما يُنظر إلى الوسيلة نفسها هل تُؤدي إلى هذا المقصود أو لا.
ثم إن قضية الغاية تبرر الوسيلة قد يُستدل بهذا على التطرق إلى الأمور المحرمة، بينما قضية الوسائل لها أحكام المقاصد هذه تَمنع وُلوجَ هذا الباب، هذا الفرق بينهما.
يقول أيضًا: هل الوسائل لها أحكام المقاصد على إطلاقها؟ لأننا نرى أن الوفاء بنذر الطاعة واجب مع أن وسيلته -وهو النذر- مكروهة، فما توجيهكم؟
مسألة النذر هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هو سأل عن النذر؟
أي نعم.
هذه فيها خلاف بين العلماء هل الوفاء بالنذر واجب أو مستحب أو محرم؟
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن على القول بأن ابتداء النذر، فالوفاء بالنذر واجب في الطاعة، لكن ابتداء النذر من أهل العلم من قال: “إنه مكروه”، ومن أهل العلم من قال: “إنه مستحب”، ومن أهل العلم من قال: “إنه محرم”.
فالأقوال ثلاثة في ابتداء النذر وهذا يُشكل على هذه القاعدة فعلاً؛ لأنه على القول بأن ابتداء النذر مكروه، كيف يصير الوفاء بالنذر واجبا؟! هذا يعتبره العلماء مستثنى من القاعدة، والسبب في هذا أنه ورد أحاديث تنهى عن النذر؛ كما في حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن النذر وقال: « إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»(٦)، وجاءت أدلة أخرى في المقابل توجب الوفاء بالنذر.
فالحاصل من هذا أن القاعدة ليست على إطلاقها بالنسبة لمسألة النذر، ولهذا العلماء قالوا: “إن مسألة النذر تُشْكِلُ؛ كيف يُنهى عن الشيء، ثم يصير الوفاء به واجبا؟!
(١) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي، القرشي، الأسدي. أبوه حواري رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمه بنت الصديق، وجدته صفية عمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعمة أبيه خديجة بنت خويلد، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة. حنكه النبي -صلى الله عليه وسلم- وسماه باسم جده، وكناه بكنيته، وأحد من وَلِيَ الخلافة. قُتل -رضي الله عنه- في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. انظر: أسد الغابة (٣/١٣٨ ترجمة ٢٩٤٧)، الإصابة (٤/٨٩ ترجمة ٤٦٨٥).
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه (١٢٦)، واللفظ له، مسلم: كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها (١٣٣٣).
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (٢١٩، ٢٢١، ٦٠٢٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها (٢٨٤، ٢٨٥) بنحوه من حديث أنس.
(٤) الأنعام: ١٠٨.
(٥) صحيح:أحمد في المسند (٨٤٤٩، ٨٤٥٢، ٨٦
الفقه
Referensi:Kaidah dengan redaksi yang sedikit berbeda ( bentuk jama’) namun tujuannya adalah sama:
[إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى
وإذا تزاحمت المفاسد ارتكبت بالأدنى ]
Jika seseorang dihadapkan pada banyak kemaslahatan maka dahulukanlah yang lebih tinggi nilai keutamaannya.
Dan jika dihadapkan pada banyak kerusakan maka ambillah /lakukanlah yang lebih ringan .
كتاب شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي – حمد الحمد
[حمد الحمد]
الرئيسية
أقسام الكتب
علوم الفقه والقواعد الفقهية
فصول الكتاب
<< < ج: ص: > >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب تزاحم المصالح والمفاسد إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى
+ – التشكيل
[إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى ]
قال المصنف رحمه الله: [فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح] إذا تزاحمت عندنا المصالح فإنا نقدم الأعلى منها، عندنا مصلحة ومصلحة وتعارضتا عند هذا المكلف، فإما أن يفعل هذه المصلحة وإما أن يفعل المصلحة الأخرى، فيقدم الأعلى منهما.
إذا أتيت إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فهل تشرع بنافلة الصبح القبلية أو تصلي الصبح؟ نقول: تصلي الفريضة مع الإمام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).إذاً: نقدم الفريضة على النافلة.وإذا كانت العبادة ذات نفع متعد كالعلم، وعارضتها عبادة ذات نفع لازم كصيام التطوع؛ فإنا نقدم العبادة ذات النفع المتعدي.
إذاً: نقدم الأعلى من المصالح.
إذا تزاحمت المفاسد ارتكبت الأدنى]
قال المصنف رحمه الله: [وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد] كذلك إذا تعارضت المفاسد وتزاحمت فإنا نرتكب الأدنى منها ونجتنب الأعلى، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: أنه لما بال الأعرابي في المسجد فزجره الناس، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لتعارض مفسدتين الأولى: البول في المسجد فينجس.
المفسدة الثانية: أن يحبس بوله فيتضرر، يعني: يلحق بدنه الضرر، وكذلك أيضاً قد ينتشر هذا في المسجد لأنه يقوم وتنتقل النجاسة إلى مواضع أخرى من المسجد.
فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام من باب الوقوع في المفسدة الصغرى، فإذا تعارضت عندنا مفسدتان قدمنا المفسدة الصغرى في الوقوع، فنقع في المفسدة الصغرى ونجتنب المفسدة الكبرى.
ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم)، متفق عليه.
فهنا عندنا مفسدة، وهي بقاء الكعبة فيها نقص من الجهة التي فيها حجر إسماعيل، فإن قريشاً قصرت بهم النفقة فقصروا البناء من جهة حجر إسماعيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم كاملة؛ لكنه خشي مفسدة أعظم، وهي أن يرتد الناس عن الإسلام لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر.
Dalil Hukumya Nadzar tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh dirubah dan tidak boleh diganti pada posisi yang lain kecuali adanya dalil yang qoth’i dan dalam kondisi dloruroh sebagaimana keterangan pada ibaroh kata yang ditebalkan.
Referensi:
الموسوعة الفقهية – ٢٦٢٢٩/٣١٩٤
الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: يَرَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ الاِعْتِكَافَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالنَّذْرِ، وَلاَ يُجْزِئُ النَّاذِرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي غَيْرِهِ، وَهَذَا قَوْل زُفَرَ وَوَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ سَوَاءٌ احْتَاجَ إِلَى شَدِّ الرِّحَال أَوْ لَمْ يَحْتَجْ (١) وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّ الاِعْتِكَافَ حَقِيقَتُهُ الاِنْكِفَافُ فِي سَائِرِ الأَْمَاكِنِ وَالتَّقَلُّبِ، كَمَا أَنَّ الصَّوْمَ انْكِفَافٌ عَنْ أَشْيَاءَ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ، فَنِسْبَةُ الاِعْتِكَافِ إِلَى الْمَكَانِ كَنِسْبَةِ الصَّوْمِ إِلَى الزَّمَانِ، وَلَوْ عَيَّنَ النَّاذِرُ يَوْمًا لِصَوْمِهِ تَعَيَّنَ عَلَى الصَّحِيحِ، فَلْيَتَعَيَّنِ الْمَسْجِدُ بِالتَّعْيِينِ أَيْضًا (٢) .
وَقَالُوا: إِنَّ مَا أَوْجَبَهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا كَانَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ أَدَاءَهُ مُقَيَّدًا بِمَكَانٍ فَلاَ يَجُوزُ أَدَاؤُهُ فِي غَيْرِهِ، كَالنَّحْرِ فِي الْحَرَمِ، وَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَكَذَلِكَ مَا أَوْجَبَهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ مُقَيَّدًا بِذَلِكَ (٣) .
وَأَضَافُوا: إِنَّ النَّاذِرَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافًا فِي مَكَانٍ مَخْصُوصٍ، فَإِنْ أَدَّى فِي غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ مُؤَدِّيًا مَا عَلَيْهِ، فَلاَ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ (٤) .
ثَانِيًا: نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي الزَّمَانِ الْمُعَيَّنِ:
٤٥ – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ عَيَّنَ زَمَانًا مُعَيَّنًا لاِعْتِكَافِهِ الْمَنْذُورِ، وَفِيمَا إِذَا كَانَ هَذَا الزَّمَانُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَمْ لاَ عَلَى اتِّجَاهَيْنِ:
الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: يَرَى أَنَّ الزَّمَانَ يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِهِ، وَيَلْزَمُ النَّاذِرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَلاَ يَعْتَكِفُ فِي غَيْرِهِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ التَّقَدُّمُ عَلَى هَذَا الزَّمَانِ بِالاِعْتِكَافِ أَوِ التَّأَخُّرُ عَنْهُ، قَال بِهَذَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ (١) .
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّذْرَ هُوَ إِيجَابُ مَا شُرِعَ فِي الْوَقْتِ نَفْلاً، وَقَدْ أَوْجَبَ النَّاذِرُ عَلَى نَفْسِهِ الاِعْتِكَافَ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْل مَجِيئِهِ، فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ لِلاِعْتِكَافِ تَعَيَّنَ لِلنَّذْرِ، وَوَجَبَ الاِعْتِكَافُ فِيهِ (٢) .
وَقَالُوا كَذَلِكَ: بِأَنَّ مَا أَوْجَبَهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا عَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا لِعِبَادَتِهِ فِيهِ تَعَيَّنَ هَذَا الْوَقْتُ لِلْعِبَادَةِ، فَكَذَلِكَ مَا أَوْجَبَهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ مِنَ اعْتِكَافٍ فِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَذَلِكَ لأَِدَائِهِ (٣) .
وَأَضَافُوا: إِنَّ النَّاذِرَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الاِعْتِكَافَ فِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنِ اعْتَكَفَ فِي غَيْرِ هَذَا الزَّمَانِ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ مُؤَدِّيًا مَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ فَلاَ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ (١) .
الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: يَرَى أَنَّ مَنْ عَيَّنَ زَمَانًا لاِعْتِكَافِهِ الْمَنْذُورِ فَإِنَّهُ لاَ يَتَعَيَّنُ بِالنَّذْرِ، وَيُجْزِئُ النَّاذِرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي زَمَانٍ غَيْرِهِ قَبْل هَذَا الزَّمَانِ الْمُعَيَّنِ أَوْ بَعْدَهُ، قَال بِهَذَا أَبُو يُوسُفَ وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .
وَاسْتَدَل أَصْحَابُ هَذَا الاِتِّجَاهِ بِأَنَّ وُجُوبَ الاِعْتِكَافِ ثَابِتٌ قَبْل الْوَقْتِ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ النَّذْرُ، فَكَانَ أَدَاؤُهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ أَدَاءً بَعْدَ الْوُجُوبِ فَيَجُوزُ، وَالدَّلِيل عَلَى تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ قَبْل الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَاجِبَةٌ عَلَى الدَّوَامِ بِشَرْطِ الإِْمْكَانِ وَانْتِفَاءِ الْحَرَجِ؛ لِقَوْل الْحَقِّ سُبْحَانَهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ (٣) ؛ وَلأَِنَّ الْعِبَادَةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّرْعَ رَخَّصَ لِلْعَبْدِ تَرْكَهَا فِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ، فَإِذَا نَذَرَ فَقَدِ اخْتَارَ الْعَزِيمَةَ وَتَرَكَ الرُّخْصَةَ، فَيَعُودُ حُكْمُ الْعَزِيمَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ لِلْحَال وَهُوَ النَّذْرُ، وَإِنَّمَا الأَْجَل تَرْفِيهٌ يُتَرَفَّهُ بِهِ فِي التَّأْخِيرِ، فَإِذَا عَجَّل فَقَدْ أَحْسَنَ فِي إِسْقَاطِ الأَْجَل فَيَجُوزُ؛ وَهَذَا لأَِنَّ صِيغَةَ النَّذْرِ لِلإِْيجَابِ، وَالأَْصْل فِي كُل لَفْظٍ مَوْجُودٍ فِي زَمَانٍ اعْتِبَارُهُ فِيهِ فِيمَا يَقْتَضِيهِ فِي وَضْعِ اللُّغَةِ، وَلاَ يَجُوزُ إِبْطَالُهُ وَلاَ تَغْيِيرُهُ إِلَى غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، إِلاَّ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ أَوْ ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ، وَلاَ ضَرُورَةَ إِلَى إِبْطَال صِيغَةِ النَّذْرِ وَلاَ إِلَى تَغْيِيرِهَا وَلاَ دَلِيل سِوَى ذِكْرِ الْوَقْتِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، فَقَدْ يُذْكَرُ لِلْوُجُوب فيه ، كَمَا فِي بَابِ الصَّلاَةِ، وَقَدْ يُذْكَرُ لِصِحَّةِ الأَْدَاءِ كَمَا فِي الْحَجِّ وَالأُْضْحِيَّةِ، وَقَدْ يُذْكَرُ لِلتَّرْفِيهِ وَالتَّوْسِعَةِ كَمَا فِي وَقْتِ الإِْقَامَةِ لِلْمُسَافِرِ وَالْحَوْل فِي بَابِ الزَّكَاةِ، فَكَانَ ذِكْرُ الْوَقْتِ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمَلاً، فَلاَ يَجُوزُ إِبْطَال صِيغَةِ الإِْيجَابِ الْمَوْجُودَةِ لِلْحَال مَعَ الاِحْتِمَال، فَبَقِيَتِ الصِّيغَةُ مُوجِبَةً، وَذِكْرُ الْوَقْتِ لِلتَّرْفِيهِ وَالتَّوْسِعَةِ، كَيْ لاَ يُؤَدِّيَ إِلَى إِبْطَال الثَّابِتِ بِيَقِينٍ إِلَى أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ
المكتبة الشاملة
كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
[البجيرمي]
ج: ٤ ص: ٣٠١
(فَصْلٌ) فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهَا نَسِيكَةً أَوْ ذَبِيحَةً وَيُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَقِيقَةً كَمَا يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الْعِشَاءِ عَتَمَةً وَهِيَ لُغَةً: الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ حِينَ وِلَادَتِهِ، وَشَرْعًا مَا يُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ لِأَنَّ مَذْبَحَهُ يُعَقُّ أَيْ يُشَقُّ وَيُقْطَعُ وَلِأَنَّ الشَّعْرَ يُحْلَقُ إذْ ذَاكَ.
وَالْأَصْلُ فِيهَا أَخْبَارٌ كَخَبَرِ «الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْمَعْنَى فِيهِ إظْهَارُ الْبِشْرِ وَالنِّعْمَةِ وَنَشْرِ النَّسَبِ وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ كَالْأُضْحِيَّةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إرَاقَةُ دَمٍ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ» وَمَعْنَى مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ قِيلَ لَا يَنْمُو نُمُوَّ مِثْلِهِ حَتَّى يَعُقَّ عَنْهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِيهِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(سُنَّ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ) بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ (أَنْ يَعُقَّ عَنْهُ) وَلَا يَعُقَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ وَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَذِكْرُ مَنْ يَعُقُّ مِنْ زِيَادَتِي
(وَهِيَ) أَيْ الْعَقِيقَة (كَضَحِيَّةِ) فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا مِنْ جِنْسِهَا وَسِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَنِيَّتِهَا وَالْأَفْضَلُ الْأَكْلُ مِنْهَا وَالتَّصَدُّقُ وَحُصُولُ السُّنَّةِ بِشَاةٍ وَلَوْ عَنْ ذَكَرٍ وَغَيْرِهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
[فَصْلٌ فِي الْعَقِيقَةِ]
مِنْ عَقَّ يَعِقُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَضَمِّهَا شَوْبَرِيٌّ، وَذَكَرهَا عَقِبَ الْأُضْحِيَّةِ؛ لِمُشَارَكَتِهَا لَهَا فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِانْفِصَالِ جَمِيعِ الْوَلَدِ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَقِيقَةً) أَيْ: لِمَا فِيهَا مِنْ التَّفَاؤُلِ بِالْعُقُوقِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ س ل؛ لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَمَّاهَا عَقِيقَةً. (قَوْلُهُ: عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ) مِنْ النَّاسِ، وَالْبَهَائِمِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ.
(قَوْلُهُ: وَشَرْعًا مَا يُذْبَحْ إلَخْ) أَيْ: مِنْ النَّعَمِ. أَقُولُ: هُوَ غَيْرُ جَامِعٍ؛ لِأَنَّ مِنْ الْعَقِيقَةِ مَا يُذْبَحُ قَبْلَ حَلْقِ الشَّعْرِ، أَوْ بَعْدَهُ، وَمَا يُذْبَحُ وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ حَلْقُ شَعْرٍ مُطْلَقًا فَإِنَّ الذَّبْحَ عِنْدَ حَلْقِ الشَّعْرِ إنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ بِأَنْ يَكُونَ يَوْمَ السَّابِعِ وَلَيْسَ مُعْتَبَرًا فِي الْحَقِيقَةِ تَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَذْبَحَهُ) عِلَّةٌ لِمُقَدَّرٍ أَيْ: وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَا يُذْبَحُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَذْبَحَهُ إلَخْ، وَالضَّمِيرُ فِي مَذْبَحِهِ رَاجِعٌ لِمَا ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ: اُنْظُرْ هَذَا التَّعْلِيلَ وَلَا تَظْهَرُ لَهُ مُلَاءَمَةٌ بِمَا قَبْلَهُ، وَلَا يَصِحُّ جَامِعًا بَيْنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَبَيْنَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ عَقَّ لُغَةً مَعْنَاهُ قَطَعَ فَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى أَسْقَطَتْهُ الْكَتَبَةُ مِنْ الشَّرْحِ بَعْدَ إثْبَاتِهِ فِيهِ مَعَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، فَيَكُونُ لَهَا فِي اللُّغَةِ مَعْنَيَانِ: الْقَطْعُ، وَالشَّعْرُ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ، وَيَكُونُ الشَّارِحُ قَدْ أَشَارَ إلَى مُنَاسَبَةِ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ فَأَشَارَ لِمُنَاسَبَتِهِ لِمَعْنَى قَطَعَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ مَذْبَحَهُ إلَخْ، وَلِمُنَاسَبَتِهِ لِمَعْنَى الشَّعْرِ بِقَوْلِهِ: وَلِأَنَّ الشَّعْرَ
إلَخْ. اهـ.
بِالْحَرْفِ. (قَوْلُهُ: يُحْلَقُ إذْ ذَاكَ) أَيْ: وَالشَّعْرُ لُغَةً يُسَمَّى عَقِيقَةً كَمَا تَقَدَّمَ ع ش. (قَوْلُهُ: كَخَبَرِ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ) لَعَلَّ التَّعْبِيرَ بِهِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْوَالِدَيْنِ بِهِ أَكْثَرُ فَقَصَدَ الشَّارِعُ حَثَّهُمْ عَلَى فِعْلِ الْعَقِيقَةِ لَهُ، وَإِلَّا فَالْأُنْثَى كَذَلِكَ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مُرْتَهَنٌ) أَيْ: مَرْهُونٌ، وَقَوْلُهُ: تُذْبَحُ حَالٌ مِنْ الْعَقِيقَةِ، وَقَوْلُهُ: وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْخَبَرِ، وَهُوَ مُرْتَهَنٌ مِنْ الْإِخْبَارِ بِالْجُمْلَةِ بَعْدَ الْإِخْبَارِ الْمُفْرَدِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى مَعْطُوفٌ عَلَى الْخَبَرِ أَيْضًا، وَيُقَدَّرُ فِيهِمَا يَوْمُ السَّابِعِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ فِيمَا قَبْلَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ: وَالْحِكْمَةُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ أَعْنِي الذَّبْحَ، وَتَالِيَيْهِ إظْهَارُ الْبِشْرِ، وَالنِّعْمَةِ رَاجِعٌ لِلْأَوَّلَيْنِ مِنْهَا، وَعَطْفُ النِّعْمَةِ تَفْسِيرٌ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ: وَنَشْرُ النَّسَبِ رَاجِعٌ لِلثَّالِثِ.
(قَوْلُهُ: كَالْأُضْحِيَّةِ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَيْهَا ح ل فَهُوَ جَوَابُ السُّؤَالِ. (قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد) اُنْظُرْ لِمَ قَدَّمَ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ؟ . اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُنْسَكَ) يُقَالُ: نَسَكَ يَنْسُكُ نُسْكًا بِفَتْحِ السِّينِ، وَضَمِّهَا فِي الْمَاضِي، وَبِضَمِّهَا فِي الْمُضَارِعِ، وَبِإِسْكَانِهَا فِي الْمَصْدَرِ شَوْبَرِيٌّ فَهُوَ مِنْ بَابِ قَتَلَ، أَوْ عَظُمَ. (قَوْلُهُ: وَمَعْنَى مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَقِبَ الْحَدِيثِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدِيهِ) أَيْ: لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لَهَا لِكَوْنِهِ صَغِيرًا، أَوْ كَبِيرًا، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ ع ش وَقِيلَ لَمْ يَشْفَعْ فِي، وَالِدَيْهِ مَعَ السَّابِقِينَ، وَانْظُرْ إذَا عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ هَلْ يَشْفَعُ فِي أَبَوَيْهِ، أَوْ لَا شَوْبَرِيٌّ.
. (قَوْلُهُ: سُنَّ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) شَمَلَ الْأُمَّ فِي وَلَدِ الزِّنَا فَيُنْدَبُ لَهَا الْعَقُّ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إظْهَارُهُ الْمُفْضِي لِظُهُورِ الْعَارِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ) إنَّمَا احْتَاجَ لِهَذَا؛ لِأَنَّهَا تُطْلَبُ مِنْ الْأَصْلِ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْعُ مُوسِرًا بِإِرْثٍ، أَوْ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَلْزَمُ الْأَصْلَ نَفَقَتُهُ فَاحْتَاجَ لِقَوْلِهِ بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ لِإِدْخَالِ هَذِهِ الصُّورَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِ) أَيْ: الْفَرْعِ. (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ إلَخْ) أَيْ: يَسَارُ الْفِطْرَةِ م ر فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَهَا فَلَا يُنْدَبُ لَهُ قَالَهُ فِي ع ب قَالَ فِي الْإِيعَابِ: وَهُوَ كَتَعْبِيرِهِمْ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَصْلَ الْمُوسِرَ بَعْدَ السِّتِّينَ أَيْ: أَكْثَرِ مُدَّةِ النِّفَاسِ لَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ تَقَعْ عَقِيقَةً بَلْ شَاةَ لَحْمٍ، وَقَوْلُهُمْ: لَا آخِرَ لِوَقْتِهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْأَصْلُ مُوسِرًا فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ، وَهَلْ فِعْلُ الْمَوْلُودِ لَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ كَذَلِكَ؟ ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ لَمَّا لَمْ يُخَاطَبْ بِهَا كَانَ هُوَ كَذَلِكَ، أَوْ تَحْصُلُ بِفِعْلٍ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ فَلَا يَنْتَفِي الثَّوَابُ فِي حَقِّهِ بِانْتِفَائِهِ فِي حَقِّ أَصْلِهِ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ الْآتِي أَنَّ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يَعِقَّ أَحَدٌ عَنْهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَعِقَّ عَنْ نَفْسِهِ يَشْهَدُ لِلثَّانِي شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُدَّةِ النِّفَاسِ) أَيْ: أَكْثَرِهَا
[أَحْكَام الْعَقِيقَة]
. (قَوْلُهُ:، وَحُصُولُ السُّنَّةِ بِشَاةٍ) أَيْ: فَلَا تَحْصُلُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ النَّعَمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِئُ كُلٌّ مِنْ الْبَقَرَةِ، وَالنَّاقَةِ عَنْ سَبْعَةٍ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ شَرْحُ م ر
……